
سيرة ومسيرة.. سلسلة حوارات مع رموز الأمة الإسلامية
( 1 ) الدكتور مجدي سعيد.. أحد رواد الإعلام العربي
حوار صحفي مع الباحث والكاتب الدكتور مجدي سعيد حول أبرز مشاريعه وتجاربه العلمية والتوثيقية
مسلمون حول العالم ـ خاص | أجرى الحوار: هاني صلاح(ألبانيا) – شادي الأيوبي (أثينا)
تستضيف منصة مسلمون حول العالم، في سلسلة حوارية، الدكتور مجدي سعيد، أحد رموز الإعلام والثقافة في العالم العربي، في حوار شامل يغطي مسيرته العملية منذ نشأته، حتى الأدوار المتعددة التي لعبها في إثراء المجتمع الإسلامي على المستويين المحلي والدولي.
 يكشف الحوار، الذي يُنشر في موقع مسلمون حول العالم، أهمَ المحطات في حياة الدكتور مجدي سعيد، بدءًا من بداياته في العمل الإعلامي والدعوي، مرورًا بتجربته الطويلة مع موقع إسلام أون لاين، ومبادراته في دعم الإعلام العلمي والمجتمعي، ومشروعاته المتنوعة مثل مبادرة “نقاط مضيئة”، وصولًا إلى مساهماته في توثيق التاريخ الشفوي والمبادرات الشبابية في مصر والعالم العربي، وتجربته في متابعة التغيير المجتمعي عبر التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة.
يكشف الحوار، الذي يُنشر في موقع مسلمون حول العالم، أهمَ المحطات في حياة الدكتور مجدي سعيد، بدءًا من بداياته في العمل الإعلامي والدعوي، مرورًا بتجربته الطويلة مع موقع إسلام أون لاين، ومبادراته في دعم الإعلام العلمي والمجتمعي، ومشروعاته المتنوعة مثل مبادرة “نقاط مضيئة”، وصولًا إلى مساهماته في توثيق التاريخ الشفوي والمبادرات الشبابية في مصر والعالم العربي، وتجربته في متابعة التغيير المجتمعي عبر التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة.
كما يتناول الحوار رؤيته لواقع المسلمين في الغرب، لا سيما في بريطانيا، والتحديات التي تواجه الأجيال الجديدة في الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية، إضافة إلى مساهماته في مشاريع إعلامية وتنموية وثقافية متعددة، التي تسلط الضوء على التجارب الإنسانية والاجتماعية الملهمة.
تابعوا معنا هذه السلسلة لتتعرفوا على قصة حياة أحد أبناء الأمة الإسلامية، وأفكاره ومبادراته ورؤاه التي تمثل مصدر إلهام لكل مهتم بالنهضة الفكرية والإعلامية والاجتماعية. كل حلقة ستكون نافذة على خبرات وتجارب قيّمة، وأفكار مبتكرة يمكن الاستفادة منها في حياتنا اليومية ومجتمعاتنا.
محور النشأة والتأثيرات الثقافية والاجتماعية المبكرة
ـ بداية، حدثنا عن نشأتك وطفولتك.
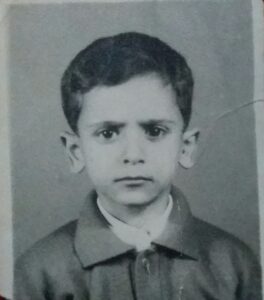 ـ وُلدت في سبتمبر 1961 في حارة حليم المتفرعة من عطفة حليم، شارع حليم في بركة الفيل. وهي إحدى مناطق السيدة زينب، المحاطة بالعديد من الآثار الإسلامية من كل جانب تقريبًا.
ـ وُلدت في سبتمبر 1961 في حارة حليم المتفرعة من عطفة حليم، شارع حليم في بركة الفيل. وهي إحدى مناطق السيدة زينب، المحاطة بالعديد من الآثار الإسلامية من كل جانب تقريبًا.
والدي، علي محمد سعيد، حصل على الشهادة الابتدائية القديمة، وكانت مدة الدراسة أربع سنوات فقط، وليس ستًا كما هو الحال الآن. جاء أبي مع والده الشيخ محمد سعيد عبد الحليم، وكان عمدة قرية الأسدية بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، وكان معه بعض إخوته الأصغر سنًا الذين جاؤوا ليستكملوا مسيرتهم التعليمية.
بدؤوا حياتهم في القاهرة باستئجار بيت في منطقة القلعة، وهناك وُلدت أختي إيمان. ثم انتقلوا إلى بيت في السيدة زينب، في الدور الرابع من حارة حليم. والدتي كانت ربة منزل، ولم تلتحق بالتعليم نظرًا للظروف الاقتصادية للأسرة، وكلاهما – أبي وأمي – من عائلة عاشور، إحدى أكبر العائلات في القرية.
ـ كيف كانت أجواء المنزل؟
ـ كانت أجواء البيت مؤثرة للغاية. باستثناء والدتي، كان موضوع القراءة حاضرًا بقوة؛ والدي كان يقرأ الصحف يوميًا ويستمع لإذاعة الـBBC، كما كان يطالع بعض الكتب الخفيفة مثل أعمال أحمد رجب وأنيس منصور. إخوتي أيضًا كانوا مولعين بالقراءة، مثل أخي محمد المهندس – رحمه الله – وأختي آيات وأختي إيمان.
ورغم أن والدتي كانت أمّية، فقد كانت تذكرني دائمًا بعمي عبد الوهاب، واسمه الكامل محمد عبد الوهاب محمد سعيد عبد الحليم، الذي أصبح لاحقًا البروفيسور محمد عبد الحليم، المتخصص في الدراسات العربية والإسلامية بجامعة لندن. كانت تحكي بإعجاب عن اجتهاده منذ الثانوية، حيث كان يدرس الثانوية العامة والأزهرية معا، وحتى اجتهاده في دار العلوم، ومنافسته على الصدارة مع زميله الدكتور أبو المكارم، وانتهاءً بتكريمه من الرئيس جمال عبد الناصر، ثم ابتعاثه للدراسات العليا في جامعة كامبريدج، وحصوله على الدكتوراه، وتعيينه في جامعة لندن بكلية الدراسات الإفريقية والشرقية.
ـ وماذا عن المؤثرات الأخرى في طفولتك؟
ـ المؤثر الثالث في المنزل كان عمي عبد الرحمن، الذي تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1970، وكان مولعًا بالشعر والرسم والموسيقى، وكذلك بالميكانيكا والهندسة العملية. سافر إلى إنجلترا لإكمال الماجستير والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وكان من الشخصيات التي تركت أثرًا عميقًا فيّ رغم أنه لم يدرك ذلك.
ـ وماذا عن البيئة الثقافية حولكم؟
ـ المنطقة كانت مليئة بالمصادر الثقافية المتنوعة. سور السيدة زينب كان يحتوي على مكتبات لبيع الكتب المستعملة، وكان هناك مكتبة دار المعارف التي كنت أشتري منها سلسلة قصص الأنبياء لمحمد أحمد برانق. كما كان هناك أيضًا رجل مسنّ، العمّ إبراهيم – رحمه الله – يبيع الفحم والبيض والمجلات القديمة مثل ميكي وسمير، وكان مسجد حسن باشا طاهر قريبًا، وقربه مكتبات للقصص والمجلات الأجنبية.
ـ ومتى بدأتَ القراءة؟
ـ بدأت منذ أن عرفت الحروف تقريبًا، مع شراء القصص والمجلات، ثم انتقلت إلى المجلات اللبنانية في الصف الرابع، وقصص الأنبياء في الصفين الخامس والسادس. لم نملك ألعابًا كثيرة، فكان إخوتي يصنعون ألعابًا من القماش وكنت أتخذ من البطاريات القديمة أبطالا لقصص متخيلة، وأختي آيات كانت تشجعني على كتابة ما أتخيله.
ـ هل من ذكريات محفورة لديكم عن أيام المدرسة الابتدائية؟
ـ أتذكر أول رحلة في الصف الأول. كانت مخصصة للصفوف العليا. بكيت حتى سمحت لي المدرسة بالانضمام. ذهبت بلا مال في جيبي، وجلست أشاهد بقية التلاميذ. ومنذ ذلك الحين حرصت على حضور جميع الرحلات المدرسية. أذكر منها رحلة من مدرسة حسن باشا طاهر إلى متحف مصطفى كامل، مشيًا على الأقدام حتى القلعة.
ـ وما أهم المؤثرات الاجتماعية؟
ـ العائلة نفسها كانت المؤثر الأكبر. جدي كان له 12 ابنًا: 10 ذكور وابنتان. البيت العائلي في السيدة زينب كان يجمع بعضهم أثناء مراحل التعليم في الزقازيق أو القاهرة. العلاقات بين الجيران كانت قوية جدًا، خاصة خلال الأعياد، حيث كانت السيدات تتجمع لصناعة الكحك، والأطفال يذهبون بالصاجات إلى الفرن. خلال حرب 1967، كنا نتجمع في الدور الأرضي لأمانِه. كانت هذه الأجواء الثقافية والاجتماعية تشكل شخصيتي واهتماماتي في مرحلة الطفولة المبكرة في السيدة زينب.
محور التطورات الثقافية والاهتمامات المبكرة في مراحل التعليم التالية وحتى التخرج
( الإعدادي والثانوي والجامعة)
ـ بعد حديثنا عن الطفولة، هل يمكنك أن تحدثنا عن المؤثرات في مرحلة الإعدادي والثانوي؟
ـ نعم. كما ذكرت، كنت مهتمًا بالقراءة منذ صغري. في عام 1973، انتقلت أسرتنا من السيدة زينب إلى حي حدائق حلوان، وهي إحدى المحطات على خط القطار القديم من محطة باب اللوق إلى محطة حلوان. كانت المنطقة آنذاك هادئة، تتكون أغلب بيوتها من فيلات أو مبانٍ منخفضة، والكثير من الأرض لم تُعمَّر بعد.
درست في مدرسة المعادي الإعدادية القديمة بمحطة المعادي، ثم التحقت بمدرسة المعادي الثانوية العسكرية، لأن المدارس الثانوية في ذلك الوقت كانت تُدرِّس مادة التربية العسكرية.
ـ وماذا عن اهتماماتك الشخصية خلال تلك المرحلة؟
ـ في الإعدادي والثانوي، بدأت أحاول أن أحاكي عمي عبد الرحمن، الذي كان مؤثرًا في موضوع الرسم والشعر. بدأت أحب الرسم بدرجة ما، وشرعت أيضًا في تجربة كتابة الشعر، رغم أن محاولاتي كانت ضعيفة جدًا، ولا أملك أيّ شيء منها الآن.
كما تأثرت بما يُنشر في صحيفة الأهرام، وخاصة فقرة “من غير عنوان” في الصفحة الأخيرة، والتي كانت تحتوي على أقوال قصيرة جدًا، سطرًا أو سطرين. كنت أقصها وأجمعها في كشكول، وبدأت أكتب خواطري الخاصة بنفس الطريقة في نهاية المرحلة الإعدادية، لكن هذه الخواطر ضاعت لاحقًا بسبب انتقالات السكن.
ـ وماذا عن القراءة الأدبية؟
ـ كنت أستعير سلسلة “المغامرين الخمسة” من زميلي في المدرسة، وأول كتاب كبير قرأته تقريبًا كان كتاب الدكتور ثروت عكاشة “إعصار من الشرق” عن التتار وغزوهم للعالم العربي والإسلامي، في السنة الإعدادية الثالثة تقريبًا. وفي أواخر الإعدادي أو أوائل الثانوي، بدأت اهتمامًا بكتابة القصة القصيرة، وشاركت في مسابقة للقصة القصيرة، رغم أن قصتي كانت ضعيفة ولم أفز.
نزلت في تلك الفترة إلى مكتبة دار المعارف في وسط البلد واشتريت كتبًا عن فن كتابة القصة القصيرة، منها كتاب ليحيى حقي، وآخر من إصدار الهيئة العامة للكتاب، لأتعلم فن القصة القصيرة، رغم أن الاهتمام لم يستمر طويلًا. وكانت لدي محاولات قليلة بعد ذلك.
ـ وهل بدأ اهتمامكم بالشؤون الدينية في تلك المرحلة؟
ـ نعم. في نهاية المرحلة الثانوية بدأت آخذ اتجاهًا دينيًا. جاءنا مدرس في المدرسة، الشيخ يوسف البدري – رحمه الله – وكان له أثر كبير. وكنت قد بدأت أصلي في المساجد وأتعرّف على جماعة التبليغ والدعوة. وخرجت معهم مرتين في الإجازة بين الثانوية العامة والإعدادي.
ـ وماذا عن الاهتمام بقضايا الأمة ووسائل الإعلام؟
ـ كنت أحاول قراءة الصحف بانتظام، خاصة الأقسام الخارجية في جريدتي الأهرام والأخبار، التي كانت تغطي القضايا الإسلامية بشكل جيد. بدأت أيضًا قراءة كتب مصطفى محمود، وكتاب للشيخ عبد الحليم محمود، وكتاب لوحيد الدين خان بعنوان “الإسلام يتحدى”، ما زاد من اهتمامي بالقراءات الدينية.
مع دخولي الجامعة (حوالي 1979–1980)، بدأت مجلة “الأمة” بالظهور، وكانت نقلة نوعية مقارنة بالمجلات السابقة مثل المختار الإسلامي، والاعتصام، والدعوة. مجلة الأمة كانت هادئة في تناول القضايا الإسلامية، مع التركيز على الأدب والفنون والعلوم والفكر الإسلامي، واهتمت أيضًا بقضايا الأقليات والجاليات المسلمة، من خلال تحقيقات تشبه أسلوب مجلة العربي. وكانت تحتوي دائمًا على لوحة من ورق كرتوني مطبوع عليها لوحة خط عربي جميل، وقد أثر هذا فيّ كثيرًا، خاصة من خلال القراءات التي كتبها الشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهما من الكتاب والمفكرين.
كما بدأت أتابع مجلات إسلامية نادرة من الجزائر واليمن والهند، وكنت أضع اسمي في قسم المراسلة في مجلة المختار الإسلامي، فتواصلت مع شباب من دول عربية وإسلامية مختلفة. ومن خلال باب المراسلة هذا وصلتني أعداد من نشرة صغيرة عن قضية قبرص التركية، ما دفعني إلى كتابة ثاني مقال نشرته عن هذه القضية في مجلة “لواء الإسلام”، بعد أول مقال نشرته بعنوان “خواطر مسلم” مستندًا على تجربتي في كتابة الخواطر والاهتمام بقضايا المسلمين.
ـ وهل كانت هناك محاولات للاستمرار في الكتابة الأدبية؟
ـ نعم، كنت أحاكي أعمدة أنيس منصور ومصطفى أمين، وأكتب خواطر لنفسي أسمّيها “صور”، أتحدث فيها عن مشاعري وأفكاري الداخلية وأعلق على أحداث الحياة الجامعية والعامة. وقد استمر هذا النشاط حتى تخرجي من كلية الطب، وكان جزءًا من تكويني الفكري والثقافي.
محور التحول من المجال الطبي إلى العمل الإعلامي وأول تجارب خارج مصر
ـ بعد تخرجك من كلية الطب، كيف بدأت تجربتك في المجال الإعلامي، وما هي أبرز المؤثرات في تلك المرحلة؟
ـ بدأت أسجل ردي عن هذه المرحلة ضمن سلسلة كنت أكتبها بعنوان “من حقيبة الذكريات”، وقد حاولت مرات عدة توثيق ما يتعلق بحياتي، لكن سأركز على النقاط الأهم. من أبرزها تحولي من العمل الطبي إلى الإعلام، والذي مرّ بعدة تجارب مهمة.
 أول تجربة كانت سفري خارج مصر لأول مرة مع لجنة الإغاثة الإنسانية أثناء الحرب في البوسنة، وكان الدكتور أشرف عبد الغفار الأمين العام للجنة. كنت وقتها سكرتير تحرير – مع زميلي الدكتور سعيد سيد – في مجلة الأطباء الصادرة عن النقابة العامة للأطباء. قابلني الدكتور أشرف خارج النقابة مساء أحد الأيام، وأخبرنا عن إمكانية السفر للعمل في أحد مكاتب اللجنة في روسيا، ففرحت كثيرًا، خصوصًا أنني كنت قد بدأت دراسة اللغة الروسية، رغم أنني لم أكملها.
أول تجربة كانت سفري خارج مصر لأول مرة مع لجنة الإغاثة الإنسانية أثناء الحرب في البوسنة، وكان الدكتور أشرف عبد الغفار الأمين العام للجنة. كنت وقتها سكرتير تحرير – مع زميلي الدكتور سعيد سيد – في مجلة الأطباء الصادرة عن النقابة العامة للأطباء. قابلني الدكتور أشرف خارج النقابة مساء أحد الأيام، وأخبرنا عن إمكانية السفر للعمل في أحد مكاتب اللجنة في روسيا، ففرحت كثيرًا، خصوصًا أنني كنت قد بدأت دراسة اللغة الروسية، رغم أنني لم أكملها.
السفر بدأ في 7 مارس 1993، حيث قضيت شهرًا في ألبانيا انتظارا للدكتور أشرف الذي كان مشغولًا حينها بعمل اللجنة أثناء حرب البوسنة. وعندما خرجت من ألبانيا مررنا يومين ببلغاريا. ثم يومين في أوكرانيا. ثم قضينا نحو أسبوعٍ في موسكو. وكان معي في هذا الرحلة الزملاء الذين سيتوزعون لاحقا على مكاتب اللجنة المختلفة. ثم وصلت إلى داغستان – ماخاتشكالا العاصمة – وأقمت هناك حوالي ثلاثة أسابيع. واجهنا بعض الصعوبات التنظيمية، مثل تأخر الميزانيات وعدم انتظام الأوراق، وعدم تلقي ردود على استفساراتنا نظرًا لانشغال الدكتور أشرف بالحرب في البوسنة.
بعد العودة، سجلت ذكرياتي وتأملاتي، مستفيدًا من تقارير كانت تنشرها جريدة المسلمون، ومنها تقارير الأستاذ أسعد طه وزيارات صحفية عدة. كما حصلت على كتاب نادر عن ألبانيا صادر في الستينيات، كتبه أحد المؤرخين، وقد أثر هذا على تسجيل ذكرياتي عن الأماكن التي زرتها، مستفيدًا من أسلوب أنيس منصور في تدوين الرحلات، خصوصًا كتابه “200 يوم حول العالم”. وقد نشرت جزءًا من تجربتي في ألبانيا لاحقًا في كتيّب صغير من مركز الإعلام العربي.
ـ كيف كانت خطوتكم التالية قبل العمل في إسلام أونلاين؟
ـ كانت هناك تجربة مهمة مع مجموعة من الأصدقاء الشباب مثل الدكتورة هبة رؤوف، والأستاذ هشام جعفر، والدكتور أحمد عبد الله، وغيرهم، ضمن ما يسمى “صالون الجنوب”. وهو صالون ثقافي يجمعنا لمناقشة تجارب مفيدة ومشاركة المعرفة. من أبرز ما خرجت به من هذا الصالون كان الاهتمام بالعمل الأهلي.
بعد دبلومة الأنثروبولوجيا، عملت كباحث ميداني في مركز ابن خلدون الذي أسسه الدكتور سعد الدين إبراهيم، حيث ساهمت في بحث عن السياسات السكانية وآخر عن الفقر والفقراء، وسجلت شهادات لأهالي المناطق المحيطة بحدائق حلوان، ما عمّق اهتمامي بالقضايا الاجتماعية: الفقر، البطالة، أطفال الشوارع وغيرها.
ثم سافرت إلى بنغلاديش لحضور برنامج تدريبي في بنك جرامين الذي أسسه البروفيسور محمد يونس. وكان لهذا أثر كبير في توسيع معرفتي ودراستي. وكتبت لاحقًا كتابًا عن تجربة بنك الفقراء. ونشرت طبعته الأولى على نفقتي عام 1999. كما كتبت مقالات عن أطفال الشوارع وقضايا أجتماعية أخرى في بعض الصحف.
ـ ومتى بدأت العمل في إسلام أونلاين؟
ـ في أواخر 1999، قابلت، أنا والأستاذ حسام السيد – رحمه الله – الأستاذ توفيق غانم وكان مدير المشروع. حيث أجرى معنا مقابلات للالتحاق بإسلام أونلاين. كان في بالي أن أؤسس صفحة للقضايا الاجتماعية التي كنت مهتما بها حينذاك. لكنهم تواصلوا معي لاحقا لأعمل بداية من أبريل 2000 كمحرر مساعد، ثم محرر للعلوم والتكنولوجيا، ثم رئيس القسم العلمي والثقافي العربي والإنجليزي. وقد شكلنا بعد ذلك فريقا، وأدخلنا استشارات صحية، وركزنا على العلوم والطب البديل، بالإضافة إلى دور العلوم والتكنولوجيا في تنمية المجتمع والشباب.
هذه الفترة كانت الأهم في حياتي المهنية، لأنها منحتني مساحة واسعة للكتابة في مجالات متعددة، ساعدتني على اكتشاف نفسي واهتماماتي الحقيقية.
محور تجربة العمل في إسلام أونلاين ومتابعة قضايا العالم
ـ كيف أثرت فترة عملك في إسلام أونلاين على اهتماماتك المهنية والفكرية، خصوصًا في ظل الأحداث الكبرى مثل الغزو الأمريكي للعراق؟
ـ في فترة عملي في إسلام أونلاين توليت مهام متعددة، ومن أبرزها إدارة صفحة خاصة قبيل وبعد الغزو الأمريكي والبريطاني للعراق، تحت عنوان حملة مناهضة الحرب الأمريكية، وذلك بمساعدة الدكتور أسامة القفّاش كمستشار تحرير، وكان مهتما بحركات مناهضة الحرب والعولمة، إضافةً إلى محررين وزملاء من الأقسام العربية والإنجليزية.
استمرت الصفحة ثلاثة أشهر، لكنها كانت مؤثرة جدًا بالنسبة لي، وأدت لاحقًا إلى إصداري لنشرة إلكترونية باسم “شعاب الحرية”، بالتعاون مع الزملاء علي منصور، وبثينة أسامة، وداليا يوسف، وأصدرت منها أربعة أعداد لا زلت أحتفظ بها.
 هذه الفترة عمّقت اهتمامي بملف العراق والاحتلال الأمريكي، ومتابعة حركة أمريكية فضحت دور الشركات الكبرى المستفيدة من الاحتلال. وكتبت مقالات مثل “شركة الاحتلال المربحة”. في الوقت نفسه، بدأت متابعة حركات التضامن مع فلسطين، خاصة بعد حادثة ريتشيل كوري وتوم هرندل. واستمرت الاهتمامات خلال أول حربٍ على غزة في 2008، مع متابعة شهادات مثل الطبيب النرويجي مادس جيلبرت، ومحاولات كسر الحصار بالقوافل البحرية “غزة حرة”. ولاحقا حضرت مؤتمرا عالميا لحركات مناهضة للحرب والعولمة في بيروت عام 2006 وكتبت عنها تقريرا مطولا.
هذه الفترة عمّقت اهتمامي بملف العراق والاحتلال الأمريكي، ومتابعة حركة أمريكية فضحت دور الشركات الكبرى المستفيدة من الاحتلال. وكتبت مقالات مثل “شركة الاحتلال المربحة”. في الوقت نفسه، بدأت متابعة حركات التضامن مع فلسطين، خاصة بعد حادثة ريتشيل كوري وتوم هرندل. واستمرت الاهتمامات خلال أول حربٍ على غزة في 2008، مع متابعة شهادات مثل الطبيب النرويجي مادس جيلبرت، ومحاولات كسر الحصار بالقوافل البحرية “غزة حرة”. ولاحقا حضرت مؤتمرا عالميا لحركات مناهضة للحرب والعولمة في بيروت عام 2006 وكتبت عنها تقريرا مطولا.
ثم جمعت أعمالي عن تلك الحركات في كتاب بعنوان “نحو حلف فضول معاصر”، وأظهرت فيه كيف يمكن لهذه الحركات أن تشكل نواة لتعاون أوسع، خصوصًا بين الجاليات الإسلامية في الغرب المهتمة بالمجال نفسه. وقبيل حرب 2021، كتبت كتابًا آخر بعنوان “المتضامنون مع فلسطين”، أرصد فيه الحركات المتضامنة مع فلسطين حول العالم، حتى من داخل المجتمع الإسرائيلي، ومن خارجه.
إسلام أونلاين رسخ لديّ ثقافة النقاش. كانت هناك اجتماعات دائمة ونقاشات مطولة، ما وسع مداركنا وفتح عقولنا، خاصة في الأقسام غير الإخبارية. الكتابة في مجالات متعددة رسخت اهتمامي بشريحتين أساسيتين: المجتمع من جهة، والخبرات والتجارب البشرية والمجتمعية من جهة أخرى. بينما كانت السياسة، رغم ضجيجها، أقل أهمية بالنسبة لي لأنها غالبًا أقل فائدة، مقارنة بالمساحة المجتمعية التي تُحدث التغيير على المدى البعيد.
وفي سنة 2010 أسست مع بعض الأصدقاء مثل أحمد عبد الحميد حسين والمهندسة حنان مجدي، “الملتقى المصري للتنشئة العلمية”، للتعرف على العاملين في مجال التنشئة العلمية من مختلف الأعمار والمبادرات، وعقد لقاءات شهرية، بدءًا من مقار الجمعيات والمبادرات وصولًا إلى ساقية الصاوي، قبل أن تؤثر الثورة على استمرارها.
كانت هذه هي أبرز مؤثرات وتجارب فترة إسلام أونلاين، والتي شكّلت قاعدة مهمة لاهتماماتي العلمية والاجتماعية والفكرية لاحقًا.
مرحلة ما بعد إسلام أونلاين وتجربة العمل في الإعلام المرئي والمطبوع
ـ ما كانت أهم محطاتك المهنية بعد انتهاء فترة عملك في إسلام أونلاين؟
ـ بعد نهاية عملي في إسلام أونلاين تقريبًا عام 2010، انتقلت إلى موقع أون إسلام بداية 2011، وهو امتداد لموقع إسلام أونلاين دون اختلاف كبير. ثم في بداية 2012 وحتى نهاية يوليو، عملت في شركة نيو ميديا المتخصصة في الأفلام الوثائقية.
كان لدي ارتباط سابق ببعض الأفلام الوثائقية، فقد ساهمت قبل ذلك في أبحاث بسيطة لأفلام عدة، منها فيلم عن فرسان مالطا. شاركت في البحث حول تاريخهم وعلاقتهم بالحروب الصليبية والماسونية. وكانت قصة مثيرة للاهتمام. كما شاركت لاحقًا في سلسلة عن تاريخ الحركات الطلابية في العالم العربي، مع التركيز على مصر، بدءًا من الاحتلال البريطاني ودور الطلبة في ثورات 1919 و1935 و1946، وصولًا إلى الحراك الطلابي في الستينيات والسبعينيات وفترة عبد الناصر وبدايات السادات بعد 1967.
 وكان لدي اهتمام شخصي بتوثيق تاريخ الحركة الطلابية بعد الستينيات. لأن تاريخ الحركة الطلابية حتى تلك الفترة مكتوب وموثق، لكن تاريخ الحركة الطلابية الإسلامية في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لم يُكتب. ومن ثمّ جمعت بيانات صادرة عنهم، وحددت عددا من الشخصيات المؤثرة في تلك الحركة، لإجراء حوارات معهم. وكانت بداية عملي مع آخرين بمشروع صغير لتوثيق الانتخابات الطلابية في الجامعات المصرية عام 1988-1989، لكن المشروع الأكبر لم يحصل على دعم، ومن ثم وُئِد في مهده.
وكان لدي اهتمام شخصي بتوثيق تاريخ الحركة الطلابية بعد الستينيات. لأن تاريخ الحركة الطلابية حتى تلك الفترة مكتوب وموثق، لكن تاريخ الحركة الطلابية الإسلامية في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لم يُكتب. ومن ثمّ جمعت بيانات صادرة عنهم، وحددت عددا من الشخصيات المؤثرة في تلك الحركة، لإجراء حوارات معهم. وكانت بداية عملي مع آخرين بمشروع صغير لتوثيق الانتخابات الطلابية في الجامعات المصرية عام 1988-1989، لكن المشروع الأكبر لم يحصل على دعم، ومن ثم وُئِد في مهده.
لاحقًا شاركت في أبحاث عدة أفلام وثائقية مع شركة نيوميديا، منها سلسلة الحروب الصليبية من أربعة أجزاء، وسلسلة تاريخ الصحافة العربية التي تضمنت 15 حلقة، مع تركيز على مصر وجمع مواد عن دول عربية أخرى. كما عملت مع شركات أخرى على أفلام عن الشريف الإدريسي الجغرافي المسلم، وفيلم عن العصيان التقني الكوبي وتأثير الحصار الأمريكي على كوبا، إلا أن هذا الأخير لم يُعرض بعد.
بعد نيو ميديا، توليت رئاسة تحرير الطبعة العربية من مجلة نيتشر، لمدة سنة ونصف في مصر، وسنتين ونصف في لندن. ثم عملت في قناة العربي ضمن قسم مراقبة الجودة لمدة سنة ونصف تقريبًا. وتبعها خمس سنوات محررا للعلوم في موقع الجزيرة نت العربي.
اعتبر هذه الفترة مرحلة تأسيسية لشخصيتي المهنية واهتماماتي الإعلامية، التي ستتضح لاحقًا في سلسلة مقالات “نقاط مضيئة” والمشاريع المرتبطة بها.
محور سلسلة مقالات “نقاط مضيئة” لتسليط الضوء على الإيجابيات في المجتمع
أهداف السلسلة: استعادة الأمل وإبراز المبادرات الملهمة بعد عام 2013
ـ حدثنا عن فكرة سلسلة مقالاتك “نقاط مضيئة” وكيف بدأت؟
ـ بدأت الفكرة بعد أحداث عام 2013 وما صاحبها من تطورات في مصر. تواصل معي مشرفو موقع مصر العربية ليطلبوا مني كتابة مقالات، فكتبت حوالي 140 مقالًا في سلسلة سميتها “نقاط مضيئة”. سبب التسمية أنني شعرت بأن الناس بعد الإحباط الذي أصابهم بعد ما حدث كانوا بحاجة لاستعادة الأمل والبحث عن الإلهام بأفكار مختلفة.
ـ وما كان محور اهتمامك في هذه المقالات؟
ـ بعد خروجي من إسلام أونلاين، ركزت على المساحة المجتمعية غير السياسية. لم أتناول السياسة إلا نادرا، لم أتجاوز مقالتين أو ثلاثًا. كان اهتمامي الأكبر بالابتكارات والمبادرات في مصر والعالم العربي، أو الشخصيات والأفكار الملهمة التي تبث الأمل وتقدم نماذج يمكن أن تلهم الناس في مجالات بعيدة عن السياسة، سواء في الدائرة الإنسانية أو العربية أو المصرية. الهدف كان التأكيد على أن التنمية الحقيقية هي أساس نهضة البلد، وأن توقف العمل بسبب الإحباط غير مقبول.
ـ وكيف تطورت هذه المبادرة بعد كتابة المقالات؟
ـ جمعت المقالات لاحقًا في ثلاثة كتب إلكترونية تحت عنوان “نقاط مضيئة”. ومع تزايد المبادرات التي كنت أتابعها عبر فيسبوك وصفحات مختلفة، ظهرت مواد كثيرة لم يكن بالإمكان تغطيتها في مقالات فحسب. لذلك بدأت استخدام هاشتاج “نقاط مضيئة” لمشاركة ما أراه مناسبًا، مع تقديم سطرين أو ثلاثة لكل مشاركة.
ـ وهل ألهمت هذه السلسلة أعمالًا أخرى؟
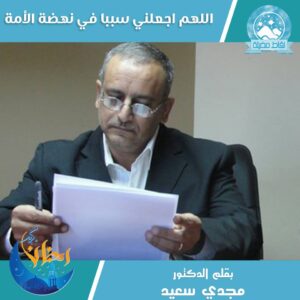 ـ نعم، ألهمتني بكتابة مقالات في “هاف بوست عربي” و”عربي بوست”، وأطلقت سلسلة جديدة سميتها “قصص ومعانٍ”، تناولت فيها شخصيات مختلفة، حتى لو حملت جوانب سلبية أو معاناة. المهم أن قصصها تحمل معنى أو رسالة. صدرت ثلاثة أجزاء من السلسلة، وهناك جزء جديد خاص بالأطفال والشباب دون سن الثامنة عشرة، جمعت فيه نحو خمسين قصة حول مشاريع اجتماعية وريادية، وأسميت الكتاب “رواد صغار”.
ـ نعم، ألهمتني بكتابة مقالات في “هاف بوست عربي” و”عربي بوست”، وأطلقت سلسلة جديدة سميتها “قصص ومعانٍ”، تناولت فيها شخصيات مختلفة، حتى لو حملت جوانب سلبية أو معاناة. المهم أن قصصها تحمل معنى أو رسالة. صدرت ثلاثة أجزاء من السلسلة، وهناك جزء جديد خاص بالأطفال والشباب دون سن الثامنة عشرة، جمعت فيه نحو خمسين قصة حول مشاريع اجتماعية وريادية، وأسميت الكتاب “رواد صغار”.
كما أصدرت كتابًا جمعت فيه 100 فكرة بسيطة ومبتكرة من أجل عالم أفضل، يركز على القضايا البيئية والاجتماعية، مستلهمًا تجارب العالم التي تستحق الإبراز.
ـ وما هو المنهج الذي اتبعته في العمل على “نقاط مضيئة”؟
ـ ركزت دائمًا على إبراز الجانب الإيجابي. لأن الناس تميل غالبًا للتركيز على الجوانب السلبية، مما يولد الإحباط. تأثرت بفكرة موقع The Better India الذي ركز على الإيجابيات في المجتمع الهندي بعيدًا عن السلبيات والتريندات المثيرة. واستفدت من هذا الأسلوب في عملي على “نقاط مضيئة”. الهدف كان تسليط الضوء على المبادرات الإنسانية والوطنية التي تبث الأمل وتلهم بالأفكار.
ـ وهل ترى أن العمل السياسي أثر على الشباب بشكل سلبي؟
ـ نعم. اكتشفت أن كثيرًا من الحركات الطلابية، سواء يسارية أو إسلامية، والحركات الإسلامية السياسية، استهلكت نفسها في صراعات سياسية مع الحكومات. وكانت النتيجة غالبًا صفرًا أو سلبية. لو تمّ توجيه اهتمام الشباب نحو النهضة والتنمية منذ البداية، لكان الوضع مختلفًا. رأيت ذلك عمليًا في مشاريع وأنشطة مثل تلك الخاصة بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ومسابقات Future City وغيرها، حيث أثبتت هذه المبادرات أثرًا إيجابيًا أكبر من العمل السياسي المستنزف للطاقة دون فائدة.
ـ وما هو هدفك الأوسع من هذه المبادرة؟
ـ الهدف الأكبر هو أن يكون بلدنا قويًا وقادرًا على الدفاع عن نفسه، خصوصًا أن الحروب الآن تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة. وللوصول إلى هذه القدرات، تحتاج بلادنا إلى تعليم وبحث علمي جيد، واقتصاد قوي، وزراعة وصناعة، واكتفاء ذاتي في الغذاء والدواء والسلاح، إلى جانب جيش قوي.
للأسف، وسائل الإعلام لم تهتم كثيرًا بهذا النوع من المحتوى. حتى في مواقع مثل الجزيرة، حيث كانت هذه الموضوعات تعتبر غير رائجة. لكن هذا زاد من إصراري على الاستمرار، حتى لو اهتم بها شخص أو شخصان فقط. إذا استطعت إلهام هؤلاء نحو شيء إيجابي يساهم في نهضة بلادنا، فذلك أفضل من الانشغال بالترندات أو الصراخ السياسي.
ـ خلاصة تجربتك مع “نقاط مضيئة”؟
ـ خلاصة الموضوع أن التركيز على المبادرات الإيجابية، على الشباب، على التعليم، على التنمية، هو السبيل الحقيقي لبناء مجتمع قوي ومجتهد، وإبراز ما يستحق الاهتمام من قصص وأفكار ملهمة، بعيدًا عن السلبية والسياسة المستنزفة.
محور تأسيس الرابطة العربية للإعلام العلمي ومساهمات محلية ودولية
أهداف الرابطة: تعزيز الإعلام العلمي وتطوير التواصل بين الصحفيين في العالم العربي
ـ حدثنا عن بداياتك في مجال الإعلام العلمي؟
ـ في بداية عملي، كنت جزءًا من القسم العلمي في موقع إسلام أونلاين. زميلتنا الدكتورة نادية العاضي حضرت مؤتمرًا دوليًا عن المياه في اليابان على ما أتذكر، وهناك تعرفت على ممثل للاتحاد الدولي للإعلام العلمي. عندما عادت ناقشت معنا الموضوع، وقررنا إنشاء رابطة عربية للإعلام العلمي. على الرغم من أنني أرى الآن أنه كان من الأفضل تأسيس رابطة مصرية أولًا، لأن البناء المحلي أقوى، إلا أننا بدأنا بالرابطة العربية عبر مجموعة إلكترونية على “ياهو”، وكان في ذلك الوقت وسيلة للتواصل بين المهتمين بموضوع ما.
ـ وكيف تطورت المبادرة بعد ذلك؟
ـ لاحقًا حضرت الدكتورة نادية مؤتمرًا آخر، ربما في إيطاليا، وهناك تعرفت على الدكتور عبدالله النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في الشارقة. كنا قبلها قد ناقشنا تسجيل الرابطة رسميا في مصر أو أي بلد عربي، أو تحت مظلة جامعة الدول العربية، لأن القوانين المحلية تمنح حقوق الأعضاء داخل البلد فقط. المؤسسة العربية دعمتنا بشكل مبدئي، وأسست الرابطة رسميًا عام 2006. ودعونا لحضور مؤتمر لهم في دمشق للمشاركة في تأسيس الرابطة تحت مظلتهم.
ـ وما كان دورك في الرابطة؟
ـ بدأت كعضو في أول مجلس إدارة، وكان لنا حضور في الاتحاد الدولي بعد تأسيس الرابطة على ” ياهو”. لاحقًا شغلت عدة مناصب، بما في ذلك رئاسة مجلس الإدارة ما بين عامي 2010 و2012. كما أسسنا لجنة للنشر لدعم الإعلام العلمي في العالم العربي، حيث أعددنا أول دليل للإعلام العلمي بمشاركة 18 إعلاميًا علميًا عربيًا، كل واحد كتب عن خبرته. وقد شاركت في الدليل، وركزت على أن الإعلام العلمي جزء من منظومة العلوم والتكنولوجيا، التي تشمل التعليم والبحث العلمي والمؤسسات والجمعيات التخصصية.
ـ هل شاركت في برامج تدريبية أو مشاريع دولية؟
 ـ نعم، كان الاتحاد الدولي يعمل على مشروع SJCOOP لتدريب الإعلاميين العلميين في إفريقيا والشرق الأوسط. اختيرت الدكتورة نادية العوضي كمنسق للمشروع في الشرق الأوسط، وتم اختياري وعدد من الزملاء كموجهين. واجهنا تحديات مثل ضعف مستوى اللغة الإنجليزية لدى بعض الإعلاميين، فقمت بترجمة بعض أجزاء البرنامج التدريبي الإلكتروني الموجود على موقع الاتحاد الدولي إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وقمت بشرحه خطوة بخطوة لتسهيل المتابعة على الزملاء. وفي لقاء لبرنامج التدريب عقده الاتحاد الدولي بالمغرب طلب مني المدير التنفيذي للاتحاد ترجمة البرنامج التدريبي كاملا باللغة العربية، وهو ما أنجزته وقامت الدكتورة نادية وزملاء آخرون بمراجعة الترجمة، ونشرت لأول مرة على موقع الاتحاد.
ـ نعم، كان الاتحاد الدولي يعمل على مشروع SJCOOP لتدريب الإعلاميين العلميين في إفريقيا والشرق الأوسط. اختيرت الدكتورة نادية العوضي كمنسق للمشروع في الشرق الأوسط، وتم اختياري وعدد من الزملاء كموجهين. واجهنا تحديات مثل ضعف مستوى اللغة الإنجليزية لدى بعض الإعلاميين، فقمت بترجمة بعض أجزاء البرنامج التدريبي الإلكتروني الموجود على موقع الاتحاد الدولي إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وقمت بشرحه خطوة بخطوة لتسهيل المتابعة على الزملاء. وفي لقاء لبرنامج التدريب عقده الاتحاد الدولي بالمغرب طلب مني المدير التنفيذي للاتحاد ترجمة البرنامج التدريبي كاملا باللغة العربية، وهو ما أنجزته وقامت الدكتورة نادية وزملاء آخرون بمراجعة الترجمة، ونشرت لأول مرة على موقع الاتحاد.
ـ وما أبرز الأنشطة التي شاركت فيها خلال هذه الفترة؟
ـ من خلال عملي كموجه في البرنامج التدريبي للاتحاد، شاركت في مهرجانات ومؤتمرات دولية، مثل EuroScience في ألمانيا عام 2006، وهو مهرجان يقدم جلسات حول أحدث التطورات العلمية وعروضًا تفاعلية للأطفال والعائلات، ضمن ما يعرف بـ Science Communication أو توصيل العلوم. وعندما عدت كتبت مقالا عن هذه الأنشطة في موقع إسلام أونلاين، كما كتبت عدة مقالات عن الأنشطة القائمة على العلوم والتكنولوجيا، وعن بعض الأفكار المتعلقة بدورهما في التنمية والنهضة، وجمعتها لاحقًا في كتاب بعنوان “العلوم والتكنولوجيا”، ركزت فيه على دور العلوم والتكنولوجيا في التغيير المجتمعي، ودور المبادرات العلمية في العالم العربي والإسلامي وخارجه.
ـ هل واجهت الرابطة تحديات؟
ـ للأسف، كانت هناك مشكلات بين أعضاء الرابطة، لكنها استطاعت تنظيم مؤتمر عربي للإعلام العلمي في المغرب عام 2008 كما فازت بحق تنظيم المؤتمر الدولي للإعلام العلم العلمي، الذي ينظمه الاتحاد الدولي كل عامين في بلد ما. وكان من المقرر تنظيم ذلك المؤتمر في مصر عام 2011، لكنه نُقل إلى قطر بسبب ظروف ما بعد الثورة. بعد ذلك ساهمت في الملتقى المصري للنشر العلمي وأنشطة متنوعة ضمن الإعلام العلمي، وهو ما يمثل مساهمتي في هذه المساحة العلمية الحيوية.
محور تجربة تأسيس موقع كلافو.. متابعة المبادرات العلمية والشبابية في العالم العربي
أهداف المشروع: تسليط الضوء على المبادرات العلمية والمجتمعية وتشجيع الشباب على المشاركة
ـ حدثنا عن تجربتك مع موقع كلافو وكيف بدأت الفكرة.
ـ تجربة كلافو كانت إحدى المحطات المهمة في مسيرتي العملية، لكن قبل الحديث عنها، أود أن أشير إلى زيارة قمت بها لمصر عام 2015، حيث كنت لا زلت أعمل حينها رئيسا لتحرير الطبعة العربية لمجلة Nature. أمضيت نحو شهر في مصر، قسمته بين أسبوعين للعمل على المجلة وأسبوعين للعطلة. قبل هذه الفترة كنت قد تابعت ظهور عدة مبادرات علمية ناشئة بعد الثورة، خاصة في مجال التواصل العلمي، مثل جمعية أصدقاء مدينة زويل، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى مثل أكاديمية التحرير وغيرها.
ـ وكيف بدأت عملية جمع المهتمين بهذه المبادرات؟
ـ بمساعدة شاب كان طالبًا في كلية طب أسنان الأزهر حينها، والذي تخرج لاحقًا وأسّس شركة متخصصة في التواصل العلمي، كنت أتابع أعماله، حيث كان يصدر مجلة علمية للأطفال اسمها “ساينس شوب”. وقد حاول أن ينظم مهرجان علوم للأطفال في الدلتا. وبالعمل سويًا قمنا بجمع بعض الشباب القائم على تلك المبادرات العلمية في لقاء نظمناه في جمعية “مساحة”، أولا ليتعرف بعضهم على بعض، وثانيا لتبادل الخبرات والأفكار حول مستقبل التواصل العلمي في مصر.
ـ من شارك في هذه اللقاءات؟
 ـ شارك عدد من الشخصيات المؤثرة، مثل الأستاذة بثينة أسامة محررة موقع “سايديف عربي”، والمهندس كريم الدجوي مدير التحرير في مجلة Nature العربية، وأحمد الغندور مؤسس قناة “الدحيح”، والدكتور شادي عبد الحافظ مؤسس مبادرة “أصدقاء الفلك” بالدلتا، وأحمد الأسدودي من فريق مجلة “الكوكب الدري” والمهندسة لمياء نائل من أكاديمية التحرير التعليمية، والمهندس محمود كشك من جمعية “أصدقاء زويل”، وشباب من مبادرة “الباحثون المصريون”، والأستاذة أمل شندي مؤسسة مبادرة “الجيولوجي الصغير”، والدكتور محمد السنباطي والذي كان يعمل في فريق تبسيط العلوم للأطفال بالجامعة الأمريكية، والمهندس أنس عماد من مبادرة “إي روبوت”، فضلا عن المهندس محمد عبود ممثلا لخبرة أنشطة جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وهو من جيل أكبر وأكثر خبرة.
ـ شارك عدد من الشخصيات المؤثرة، مثل الأستاذة بثينة أسامة محررة موقع “سايديف عربي”، والمهندس كريم الدجوي مدير التحرير في مجلة Nature العربية، وأحمد الغندور مؤسس قناة “الدحيح”، والدكتور شادي عبد الحافظ مؤسس مبادرة “أصدقاء الفلك” بالدلتا، وأحمد الأسدودي من فريق مجلة “الكوكب الدري” والمهندسة لمياء نائل من أكاديمية التحرير التعليمية، والمهندس محمود كشك من جمعية “أصدقاء زويل”، وشباب من مبادرة “الباحثون المصريون”، والأستاذة أمل شندي مؤسسة مبادرة “الجيولوجي الصغير”، والدكتور محمد السنباطي والذي كان يعمل في فريق تبسيط العلوم للأطفال بالجامعة الأمريكية، والمهندس أنس عماد من مبادرة “إي روبوت”، فضلا عن المهندس محمد عبود ممثلا لخبرة أنشطة جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وهو من جيل أكبر وأكثر خبرة.
ـ ماذا حدث بعد اللقاء الأول؟
ـ بعد اللقاء الأول، نظمنا لقاءً ثانيا مصغرًا ضم مجموعة من الأفراد الذين رأينا أنهم قادرون على تقديم شيء مفيد. حضر هذا اللقاء المهندس محمد عبود، أحد مؤسسي أنشطة IEEE في مصر ويوم الهندسة، والذي أضاف خبرة كبيرة في تنظيم الفعاليات والمسابقات العلمية. ومن هذا اللقاء الثاني انطلقت فكرة أسبوع العلوم المصري، الذي أُقيم مرتين، ثم تطور لاحقًا إلى أسبوع العلوم العربي على مستوى العالم العربي.
ـ متى تأسس موقع كلافو وما هدفه؟
ـ كان من أحلامي في لقائنا أن تكون هناك منصة إعلامية تتحدث عن المبادرات الشبابية. وقد تحمس الأستاذ حسام السيد – رحمه الله – للفكرة، وكان حاضرا في لقائنا الثاني المصغر. ومن هنا نشأت فكرة تأسيس مشروع إعلامي يتابع أنشطة المبادرات العلمية وغير العلمية ويتابع الفرص المتاحة أمام الشباب العربي. وعلى هذا الأساس جاءت مبادرة موقع clavo.me والتي استمرت من النصف الثاني لعام 2016 إلى عام 2017. ورغم الجهد الكبير وإنتاجنا لمحتوى متنوع من فيديوهات وتقارير وأخبار، لم تحقق التجربة النجاح المرجو بسبب ضيق الميزانية، إذ كانت الشركة الداعمة للموقع، وهي شركة O2، تصرف بشكل محدود على المشروع بسبب تعدد مشاريعها الأخرى، بما فيها مصر العربية، ثم توقف التمويل تماما بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
ـ وماذا كانت النتائج؟
ـ نتيجة لذلك توقفت مبادرة كلافو، رغم القيمة التي قدمناها في متابعة المبادرات المختلفة على مستوى العالم العربي وتسليط الضوء على الفرص المتاحة للشباب. وللأسف، لم يعد الموقع موجودًا الآن، وثقنا المواد التي أنتجت عليه ومنها بعض الفيديوهات المتميزة، وبقيت مستحقات مالية للعديد من العاملين معنا، ما شكل صعوبة إضافية.
ـ وكيف تنظر اليوم إلى تجربة كلافو؟
ـ بالرغم من التحديات المالية والإدارية، يظل مشروع كلافو محطة مهمة في مسيرتي. إذ كان جزءًا من اهتمامي المستمر بمبادرات الشباب، واهتمامي بنشر الأخبار الإيجابية والمبادرات المختلفة على مستوى العالم العربي. وهو مشروع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم “نقاط مضيئة” الذي تناولته في أعمالي السابقة، وهو ما يمثل رؤية شاملة لدعم الشباب وتسليط الضوء على الإنجازات والمبادرات المجتمعية.
محور توثيق التجارب التاريخية والمجتمعية والفكرية ونشر المعرفة للأجيال القادمة
ـ نود أن نتعرف على أبرز المشاريع والكتب التي عملت عليها في مسيرتك العلمية والبحثية. من أين تبدأ؟
ـ البداية كانت مع مشروع بنك الفقراء التابع لمؤسسة جرامين، الذي شكل تجربة مهمة في التعرف على آليات التمويل المجتمعي وكيفية دعم الفئات الأكثر احتياجًا. بعدها شاركت في مؤتمر أُقيم بمكتبة الإسكندرية عام 2005 حول مئوية الإمام محمد عبده، رحمه الله، الذي توفي عام 1905. أشرف على المؤتمر عدد من الأكاديميين المتميزين، ومن بينهم صديقي الدكتور إبراهيم البيومي غانم، المستشار في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وله إسهامات مهمة في الدراسات المتعلقة بالأوقاف.
ـ وهل كان لك نشاط بحثي خلال هذا المشروع؟
ـ نعم. فقد كلفني الدكتور إبراهيم بإعداد بحث حول العمل الأهلي في تجربة الإمام محمد عبده. ومن ثم زرت عدة مكتبات مصرية لجمع المادة. كما زرت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية التي أسسها الإمام محمد عبده في أواخر القرن التاسع عشر. وجمعت مصادر تاريخية كثيرة. وأعددت بحثًا يستعرض السياق التاريخي والاجتماعي للأنشطة الأهلية والإسلامية في مصر خلال القرن التاسع عشر. هذا البحث نُشر ضمن أعمال المؤتمر، ثم نشرت البحث منفردا في كتيب على نفقتي، مع إضافات بسيطة تضمنت مصادر جديدة اكتشفتها لاحقًا.
ـ وماذا عن مشروعاتك الأخرى؟
ـ المشروع الثاني الذي أعتبره مهمًا تناول تاريخ التعاونيات في مصر: مسار تطورها وانحدارها، وكيفية إعادة نهضتها. جاء ذلك بناءً على طلب من صديقي رجل الأعمال الأستاذ محمد منصور أبو عوف، الذي قرأ كتابي عن تجربة بنك الفقراء وناقشني فيه، ثم طلب مني إعداد دراسة عن حركة التعاونيات التي نشأت في مصر عام 1908، وذلك ضمن الأفكار التي خرجت من نادي المدارس العليا الذي أسسه الحزب الوطني القديم. وقد قمت أيضا بالطواف بالمكتبات لجمع مادة الدراسة، وزرت مقر الاتحاد التعاوني المصري، وصدرت الدراسة التي تتناول مراحل تاريخ التعاونيات في مصر، صعودها وتدهورها، ودراسة تأثير تدخل الدولة على هذا المسار.
ـ هل كان لك عمل في مجال الفكر الإسلامي؟
ـ بين 2010 و2012 عملت ضمن فريق الباحثين في مشروع “في الفكر النهضوي الإسلامي” الذي كانت تشرف عليه مكتبة الإسكندرية، تحت إشراف د. محمد عمارة، ود. محمد كمال الدين إمام، ود. إبراهيم البيومي غانم. ركز المشروع على اختيار مئة كتاب صدرت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين وتحمل فكرا نهضويا، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الذي يسهم في نهضة الأمة. وفي إطار عملي شاركت في مراجعة ودراسة عدد من هذه الكتب، منها كتاب “طبائع الاستبداد” للكواكبي، و”الإسلام دين الفطرة والحرية” للشيخ عبد العزيز جاويش، و”المسألة الشرقية” لمصطفى كامل، مع توثيق السياق التاريخي لصدور كل منها، والتعريف بالمؤلف وأعماله الأخرى، وبالكتاب الذي يتم تناوله. وصدرت الكتب عن المكتبة ودار الكتاب المصري واللبناني، ثم جمعت المقدمات في كتاب إلكتروني على مدونتي بعنوان: في سبيل النهضة والاستقلال.. قراءة في الأسس المعنوية من خلال ثلاثة كتب، وذلك في عام 2018.
ـ وهل توسعت في أعمال التوثيق لاحقًا؟
 ـ نعم، في منتصف 2023 وبعد تركي العملَ في الجزيرة، بدأت في 2024 مشاريع للتأريخ الشفوي تتناول عدة موضوعات وصدرت في 3 كتب. أولها كتاب “روح التطوع المهني” ويتناول ربع قرن من أنشطة الطلاب والخريجين من أقسام الحاسبات والإلكترونيات والكهرباء وهندسة الاتصالات، حيث سجلت نحو 80 لقاءً مع شخصيات مرتبطة بتلك الأنشطة في مصر منذ عام 1999 وحتى عام 2024، وكان الهدف توثيق أثر هذا النشاط الطلابي والشبابي على نهضة المجتمع.
ـ نعم، في منتصف 2023 وبعد تركي العملَ في الجزيرة، بدأت في 2024 مشاريع للتأريخ الشفوي تتناول عدة موضوعات وصدرت في 3 كتب. أولها كتاب “روح التطوع المهني” ويتناول ربع قرن من أنشطة الطلاب والخريجين من أقسام الحاسبات والإلكترونيات والكهرباء وهندسة الاتصالات، حيث سجلت نحو 80 لقاءً مع شخصيات مرتبطة بتلك الأنشطة في مصر منذ عام 1999 وحتى عام 2024، وكان الهدف توثيق أثر هذا النشاط الطلابي والشبابي على نهضة المجتمع.
كما عملت بعد ذلك على مشروع توثيقي حول الوضع الطبي والإنساني في غزة أثناء الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، بتكليف من الجمعية العالمية للمهن الطبية. حيث أجريت ما يقارب 30 لقاء مع أطباء عملوا في غزة، وأعددت كتابًا بعنوان “يوميات جراح في غزة”، صدر في يناير 2025 وترجم إلى الإنجليزية والبنغالية لاحقا، لتوثيق الجهود والأوضاع الإنسانية والطبية خلال الحرب.
ـ هل لديك مشاريع توثيقية أخرى؟
 ـ كان الكتاب الثالث هو كتاب “من حكايات السائرين”، الذي يهدف لتوثيق تجارب شخصيات عربية تركت بلادها لتعيش وتعمل في بلدان أخرى حول العالم وكان لها أدوار مهمة في تلك البلدان. كان الحافز على الاهتمام بتلك التجارب ألا يتكرر مثل ما حدث مع شخصيات عظيمة رحلت دون أن توثق إسهاماتها مثل الدكتور الفاتح علي حسنين، والدكتور عبد الرحمن السميط وغيرهما. ومن ثم أردت تسليط الضوء على مساهمات شخصيات لا زالت حية وتعمل في بلدان مختلفة حول العالم.
ـ كان الكتاب الثالث هو كتاب “من حكايات السائرين”، الذي يهدف لتوثيق تجارب شخصيات عربية تركت بلادها لتعيش وتعمل في بلدان أخرى حول العالم وكان لها أدوار مهمة في تلك البلدان. كان الحافز على الاهتمام بتلك التجارب ألا يتكرر مثل ما حدث مع شخصيات عظيمة رحلت دون أن توثق إسهاماتها مثل الدكتور الفاتح علي حسنين، والدكتور عبد الرحمن السميط وغيرهما. ومن ثم أردت تسليط الضوء على مساهمات شخصيات لا زالت حية وتعمل في بلدان مختلفة حول العالم.
كان الحافز الأكبر على أن أخوض في مشاريع التأريخ الشفهي تلك هو الإلهام الذي مثله لي كتاب “حكاية العربي”، الذي وثق تجربة الحاج محمود العربي وعائلته الذين انتقلوا من العمل بالتجارة إلى خوض غمار الصناعة، وصاروا من أكبر الشركات العائلية في مصر. وكانوا في مسيرتهم نموذجا ملهما للكثيرين، وكان هذا الكتاب سببا في هذا الإلهام لرواد الأعمال. كما كان سببا في إلهامي بالسعي لتوثيق الخبرات والتجارب المحلية، سواء أكانت هادفة للربح أم غير هادفة له.
ـ وكيف تصف أهمية هذه المشاريع بالنسبة لك؟
ـ هذه المشاريع والكتب تمثل شغفي المتنامي بتوثيق الخبرات والتجارب الإنسانية في مصر والعالم العربي. سواء في المجال الأهلي أو العلمي أو المدني أو المهني، لضمان استمرار المعرفة ونقلها للأجيال القادمة، بما يحقق في النهاية أهداف زيادة الأمل وتحقيق الإلهام.
الانتقال إلى بريطانيا.. أوضاع المسلمين والتحديات التعليمية والاجتماعية
ـ متى جئتم إلى بريطانيا، وما كان انطباعك عن وضع المسلمين هناك؟
 ـ جئت إلى بريطانيا في 30 مارس 2014، وكنت في سن الثانية والخمسين. في البداية ركزت أكثر على عملي وأداء صلاة الجمعة في المساجد القريبة، دون الانخراط الكبير في أنشطة الجالية، لكن يمكنني تقديم بعض الملاحظات حول وضع المسلمين هنا.
ـ جئت إلى بريطانيا في 30 مارس 2014، وكنت في سن الثانية والخمسين. في البداية ركزت أكثر على عملي وأداء صلاة الجمعة في المساجد القريبة، دون الانخراط الكبير في أنشطة الجالية، لكن يمكنني تقديم بعض الملاحظات حول وضع المسلمين هنا.
المسلمون في بريطانيا يشكلون إحدى أكبر الأقليات في أوروبا، والغالبية العظمى منهم من شبه القارة الهندية بمختلف تقسيماتها مثل الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا، يليهم الجالية الصومالية، ثم باقي الجاليات العربية والتركية، وهناك أيضًا مسلمون من الجزر الكاريبية، وإن كانوا أقل انخراطًا في النشاط الديني.
ـ هل هناك اختلاف بين الجاليات من حيث الفقه والممارسة الدينية؟
ـ نعم. كل جالية تأتي إلى هنا بفقهها وفكرها الإسلامي الخاص. الجاليات الهندية والباكستانية لديها مدارس فكرية مختلفة. وبعض ممارساتهم قد تقترب أحيانًا من المظهر السلفي، مع الاحتفاظ بجوانب صوفية وتبليغية. وهم من أكثر الناس نشاطًا، لديهم مؤسسات تعليمية ودعوية مؤثرة، لكنهم جاؤوا من بيئات وثقافات دينية محددة. ولم يحدث تعديل كبير في فقههم تبعًا للبلد الجديد. وهذا يلاحظ خصوصًا عند الأجيال الأولى منهم.
ـ وكيف يؤثر ذلك على الأجيال التالية؟
 ـ الأجيال الأولى، بسبب تركيزهم على العمل والتعليم، يربون أبناءهم على نفس المنهج، بينما الأجيال الثانية والثالثة قد تنفك تدريجيًا عن هذا التأثير.
ـ الأجيال الأولى، بسبب تركيزهم على العمل والتعليم، يربون أبناءهم على نفس المنهج، بينما الأجيال الثانية والثالثة قد تنفك تدريجيًا عن هذا التأثير.
بالنسبة لخطبة الجمعة، عادة ما يكون هناك درس قبل الخطبة باللغة الإنجليزية أو البنغالية أو الأردية حسب الجالية، ثم الخطبة نفسها قصيرة باللغة العربية ومكررة. وفي بعض المساجد الكبيرة، مثل المسجد الرئيسي قرب المستشفى العام في حي كرويدون الذي أسكن فيه حاليا، الخطبة ثابتة، بغض النظر عن الخطيب، بينما الدروس تُقدم باللغة المناسبة للجالية.
الجالية الصومالية غالبًا ما تكون خطبتها بالإنجليزية، وهذا جيد لأن الخطبة يجب أن تكون بلغة البلد الذي يعيش فيه الناس، خاصةً أن المساجد مفتوحة لجميع الجاليات. أحيانًا، عند تغيير التوقيت الصيفي والشتوي، يكون هناك صلاتان للجمعة، واحدة بالدرس البنغالي والأخرى بالإنجليزي. والخطبة بالعربية لكلا الصلاتين، ما يجعلها موحدة رغم اختلاف اللغات في الدروس.
ـ ما رؤيتك لمستقبل المسلمين في بريطانيا؟
المستقبل يعتمد على إعداد جيل من المسلمين الجدد من أهل البلاد الأصليين، ممن درسوا في جامعات محلية، ثم يواصلون تعليمهم في جامعات البلاد الإسلامية مثل الأزهر، أو تركيا، أو المغرب، ثم يعودون لإكمال دراساتهم العليا في الغرب. وبهذا يكونون مزودين بالثقافتين الإسلامية والغربية. هذا يمنحهم فهمًا أعمق للثقافة المحلية في بلادهم، ويسهم في نشر الدين بطريقة متوازنة. الأجيال الثانية والثالثة، التي وُلدت هنا أو نشأت في هذه البيئة، يمكن أن يكون لها أيضا دور إيجابي بنفس الطريقة، أو إذا توفرت لهم مؤسسات تعليمية ودعوية تحميهم من الانحراف.
ـ هل هناك تحديات تواجه الأجيال الجديدة؟
 ـ بالتأكيد، بعض الشباب من الأجيال الثانية والثالثة قد يبتعدون عن الدين أو تقل ممارستهم للشعائر. وهناك من يواجه مشاكل اجتماعية مثل الجنوح، المخدرات، الجرائم، أو مشاكل أسرية كالطلاق والتفكك الأسري.
ـ بالتأكيد، بعض الشباب من الأجيال الثانية والثالثة قد يبتعدون عن الدين أو تقل ممارستهم للشعائر. وهناك من يواجه مشاكل اجتماعية مثل الجنوح، المخدرات، الجرائم، أو مشاكل أسرية كالطلاق والتفكك الأسري.
دعم المسلمين الجدد، خصوصًا من لديهم معرفة جيدة بالإسلام، له أثر كبير في الحفاظ على الدين والهوية الإسلامية. الأجيال الجديدة تحتاج لفهم ثقافة البلد ومراعاة أولويات المكان والزمان، وهذا يتطلب مؤسسات داعمة توفر بيئة تعليمية ودعوية متكاملة، كما كان موجودًا في أوروبا في بعض البلاد مثل الكلية الإسلامية الأوروبية التي كانت موجودة في فرنسا مثلا، أو كلية كمبريدج الإسلامية التي أسسها عبد الحكيم مراد وهو من المسلمين الجدد الذين توافرت فيهم الشروط التي ذكرتها.
ـ وما أثر الأحداث العالمية على المسلمين في بريطانيا؟
ـ المسلمون هنا، بجانب الحفاظ على دينهم، يتأثرون بالأحداث العالمية مثل حرب غزة، حيث تظهر مشاعر عاطفية واسعة. يمكن البناء على هذه المشاعر لتعزيز الوعي الديني والاجتماعي. في النهاية، من المهم التعاون فيما اتفقنا عليه مع الحركات الشعبية العالمية المتضامنة مع قضايانا، والتي توسعت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر 2023، مع ضرورة احترام الاختلافات، والتركيز على دعم الأجيال الجديدة وتمكينها علميًا ودينيًا واجتماعيًا.
محور تجربة إسلام أون لاين
ـ حدثنا عن تجربتك مع موقع إسلام أون لاين وما الذي ميزها؟
ـ تجربتي مع موقع إسلام أونلاين كانت رائعة جدًا. بالنسبة للأشخاص الذين كانوا داخل الموقع، كانت التجربة مثمرة للغاية، أما بالنسبة للذين كانوا خارج الموقع فقد تختلف تقييماتهم. عشت تجربة إسلام أونلاين حوالي عشر سنوات، تلتها سنة مع On Islam، الذي كان امتدادًا للموقع السابق. التجربة كانت مميزة من حيث تبادل الأفكار والنقاشات، خاصة في الأقسام غير المرتبطة بالأخبار السريعة، حيث كانت النقاشات معمقة وتفتح الذهن وتساهم في تطوير وعي الشخص وتحسين طلاقة أفكاره.
ـ ما كان دورك داخل الموقع؟
ـ كنت متاحًا لكتابة مقالات في مجالات متنوعة، مثل الثقافة والعلوم، بغض النظر عن الوظيفة التي أشغلها داخل الموقع. اقترحت تأسيس قسم خاص ببحوث الإنترنت وتأثيراته المجتمعية، وعملت فيه لبعض الوقت، ثم تولاه آخرون. كما كنت مديرا لتحرير صفحة نماء المختصة بالتنمية من الأسفل، أي التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المجتمع المحلي والجذور الشعبية، لا على مستوى السياسات الدولية أو الدولة.
ـ هل كانت هناك مشاريع أخرى مرتبطة بالموقع؟
ـ نعم، كانت هناك مشاريع تابعة لشركة Media International، منها مشروع ضخم اسمه بيبليو إسلام، وهو موقع كان يقدم خدمة ملخصات الأبحاث والكتب في العلوم الإنسانية للباحثين، كان على رأسه الأستاذ الدكتور هاني عطية، رحمه الله، عمل فيه لفترة طويلة مع فريق من الشباب. كما كان هناك موقع شبابي اسمه عشرينات مختص بمخاطبة الأجيال الأصغر.
ـ هل هناك مشاريع أخرى ذات طابع ثقافي أو معرفي؟
ـ نعم، كان هناك مشروع متعلق بنشر سلاسل كتب، وقد نشرت الطبعة الثانية من كتابي تجربة بنك الفقراء من خلاله، كما نشر المشروع كتبا أخرى اجتماعية وشبابية وتنموية وغيرها.
ـ كيف تصف التجربة إجمالًا؟
 تجربة إسلام أونلاين كانت شاملة ومتكاملة. أتاحت لي فرصة العمل في مجالات مختلفة. وكانت فريدة من نوعها بالنسبة لي. لم أشهد تجربة مشابهة حتى عند عملي في مؤسسات كبيرة مثل الجزيرة ونيتشر، حيث الدمج بين مجلات ودوريات علمية ضخمة ومحترفة. لكن بينما كانت بيئة العمل في نيتشر بيئة احترافية ومريحة نفسيا، فأن بيئة العمل في المشاريع الإعلامية العربية كانت صعبة، ومليئة بالتحديات، بما فيها التوترات بين الجنسيات وتخبط الإدارات والأهواء التي تحركها أحيانا.
تجربة إسلام أونلاين كانت شاملة ومتكاملة. أتاحت لي فرصة العمل في مجالات مختلفة. وكانت فريدة من نوعها بالنسبة لي. لم أشهد تجربة مشابهة حتى عند عملي في مؤسسات كبيرة مثل الجزيرة ونيتشر، حيث الدمج بين مجلات ودوريات علمية ضخمة ومحترفة. لكن بينما كانت بيئة العمل في نيتشر بيئة احترافية ومريحة نفسيا، فأن بيئة العمل في المشاريع الإعلامية العربية كانت صعبة، ومليئة بالتحديات، بما فيها التوترات بين الجنسيات وتخبط الإدارات والأهواء التي تحركها أحيانا.
ـ وما الذي أدى إلى إغلاق موقع إسلام أونلاين؟
ـ أعتقد أن قرار الإغلاق جاء بعد ضغوط سياسية خارجية ومحلية. حيث كان الهدف تحويل الموقع ليقتصر على الشؤون الدينية فقط. رغم أن الأساس كان متنوعًا وشاملًا لمجالات ثقافية وعلمية وسياسية واقتصادية واجتماعية متعددة. هذا أثر على استمرارية التجربة وإمكاناتها، لكنها تبقى تجربة مهمة ومؤثرة في مجال الإعلام الإسلامي على الإنترنت.
محور تقييم دور مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلام اليوم
ـ ما تقييمك لدور مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلام اليوم؟
 ـ الحقيقة أنني لست الأكثر قدرة على الحكم، لكن يمكنني إبداء بعض الرأي. أرى أن هناك توسعا شديدًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت تحل محل العديد من الوسائط الأخرى، مثل البرامج الحوارية في القنوات التلفزيونية، وأحيانًا حتى الأخبار، حيث تتسم بالسرعة مقارنة بالقنوات الفضائية المتخصصة. هذا الوضع يحتاج إلى متابعة مستمرة. فكلما تطورت التكنولوجيا، تطورت الاستخدامات الإعلامية بسرعة. ويجب أن يكون لأي مشروع إعلامي القدرة على مواكبة هذه التطورات.
ـ الحقيقة أنني لست الأكثر قدرة على الحكم، لكن يمكنني إبداء بعض الرأي. أرى أن هناك توسعا شديدًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت تحل محل العديد من الوسائط الأخرى، مثل البرامج الحوارية في القنوات التلفزيونية، وأحيانًا حتى الأخبار، حيث تتسم بالسرعة مقارنة بالقنوات الفضائية المتخصصة. هذا الوضع يحتاج إلى متابعة مستمرة. فكلما تطورت التكنولوجيا، تطورت الاستخدامات الإعلامية بسرعة. ويجب أن يكون لأي مشروع إعلامي القدرة على مواكبة هذه التطورات.
ـ هل هناك اختلاف بين المؤسسات الإعلامية الكبيرة والصغيرة في التعامل مع هذه التطورات؟
ـ نعم. أي مؤسسة إعلامية كبيرة غالبًا ما تكون بطيئة في التغيير واتخاذ القرارات. بينما المؤسسات الصغيرة والخفيفة الحركة تستطيع تطوير نفسها بسرعة والتكيف مع الجديد. مثال على ذلك تجربة إسلام أونلاين، التي تحولت مع الوقت إلى مؤسسة كبيرة تضم نحو 300 شخص بين موظفين ومتعاونين، ما جعل عملية التغيير فيها أبطأ، مقارنة بالمؤسسات الصغيرة.
ـ ماذا عن المشاريع الإعلامية الحديثة مثل البودكاست؟
 ـ في الوقت الحالي، أصبحت منصات مثل البودكاست منتشرة بشكل واسع في العالم العربي. ويوجد ثراء كبير في المحتوى، بما في ذلك القضايا السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية. البودكاست وغيره من المشاريع الإعلامية الصغيرة توفر محتوى أسرع وأكثر تأثيرًا وأحيانًا أكثر نجاعة من بعض القنوات الفضائية الكبرى، حيث يمكن الوصول إلى موضوعات متنوعة بشكل مباشر وجاذب للجمهور.
ـ في الوقت الحالي، أصبحت منصات مثل البودكاست منتشرة بشكل واسع في العالم العربي. ويوجد ثراء كبير في المحتوى، بما في ذلك القضايا السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية. البودكاست وغيره من المشاريع الإعلامية الصغيرة توفر محتوى أسرع وأكثر تأثيرًا وأحيانًا أكثر نجاعة من بعض القنوات الفضائية الكبرى، حيث يمكن الوصول إلى موضوعات متنوعة بشكل مباشر وجاذب للجمهور.
ـ كيف ترى مستقبل الإعلام العربي في ظل هذه التطورات؟
ـ المستقبل يسير في هذا الاتجاه، مع مزيد من الاعتماد على التطورات التكنولوجية واستخداماتها العالمية في صناعة المحتوى. هناك محتوى عربي ضخم عبر منصات التواصل الاجتماعي، يغطي مجالات الرياضة والأعمال والاقتصاد والسياسة والدين، خصوصًا في مصر والخليج. لكن بعض المجالات الأخرى قد لا يحظى بنفس العمق أو الكثرة. بشكل عام، وسائل التواصل الاجتماعي اليوم توفر إمكانيات كبيرة لأي مشروع إعلامي لمواكبة التطورات وتقديم محتوى متنوع وفاعل.
.. رسالة الحوار ..
في ختام هذا الحوار، يمكن تلخيص رسالة الدكتور مجدي سعيد في أن البناء الحقيقي للأمة يكمن في الاستثمار في الإنسان والمجتمع عبر التعليم، البحث العلمي، المبادرات المجتمعية، والإعلام الإيجابي. مؤكدًا أن التركيز على ما يُلهم الشباب ويحفزهم على الإبداع والعمل البنّاء يحقق نهضة حقيقية، ويعيد الأمل إلى المجتمعات بعد الفترات الصعبة، بعيدًا عن السلبية والصراعات السياسية المستنزفة. وتجربته الممتدة عبر الإعلام، البحث العلمي، وتوثيق التاريخ الشفوي، تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية الجمع بين الفكر والعمل والمبادرة لخدمة الأمة الإسلامية وإثراء الحضارة الإنسانية.

